لماذا هو صالح لكل زمان ومكان ؟
منذ 8 سنة | 6568 مشاهدات
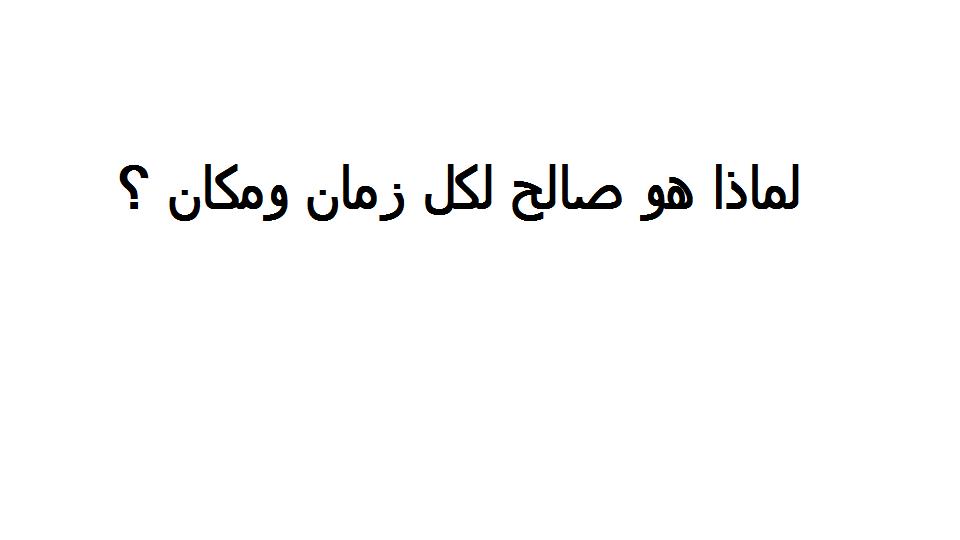
يعترض بعض مثقفينا العلمانيين على مقولة أن "الإسلام صالح لكل زمان ومكان"، وعندما يحاول هؤلاء المعترضون أن يأتوا بشواهد لتأييد وجهة نظرهم فإنهم يضربون أمثلة من بعض الأحكام الفقهية التي استنبطها السلف وعملوا بها بينما يبدو الآن أنها لم تعد ملائمة لزماننا أو تتعارض تعارضا واضحا مع بعض ما نسلم أنه حقائق علمية، وهذه الشواهد تصلح طبعا لتأييد الدعوى القائلة بأن أحكام الفقه نسبية (ليست مطلقة الصحة) وتاريخية (خاضعة لظروف عصرها)، ونحن نؤيد هذه الدعوى ونقبلها، لكنها لا تصلح بالقطع عندما يكون الكلام عن الشريعة نفسها .. فنحن نؤمن أن الشريعة – التي نجدها في الكتاب والسنة الصحيحة – هي الصالحة لكل زمان ومكان، أما الأحكام الفقهية المستنبطة من هذه الشريعة فهي عندنا فكر بشري ينسب لصاحبه، يحتمل الخطأ والصواب، ويرتبط بظروفه التاريخية وبيئته الاجتماعية، يمكن، بل يجب، أن يعاد النظر فيه كلما تغيرت الظروف التي أنتجته.
تسير الطبيعة طبقا لنفس النواميس وتخضع لذات القوى منذ خلق الله الدنيا، لكن الطريقة التي نفهم بها هذه الطبيعة تتغير والنظريات والقوانين التي نصوغها لتفسيرها والتحكم فيها تتبدل مع الزمن .. وأنظر إلى قضية من أشهر القضايا في تاريخ العلم، دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس .. لقد وضع علم الفلك القديم نموذج بطليموس الذي يتصور أن الأرض ثابتة في مركز الكون وتدور كل الأجرام الفلكية حولها، وأعطت المعادلات التي تصف هذا النموذج نتائج غالبا ما كانت تبدو متسقة مع معطيات الرصد، ومن ثم صارت مقبولة تماما من كل العلماء، ثم جاء كوبر نيكوس بنموذجه عن دوران الأرض حول الشمس محدثا ثورة شاملة في علم الفلك .. لكن كوبر نيكوس لم يرصد أية حركات مختلفة عما رصده بطليموس وأتباعه، كانت نظرية كوبر نيكوس ومعادلاته تنطلق من ذات المشاهدات، ذات الحقائق، ورغم ذلك فقد فهمها فهما مختلفا دون أن يزعم أحد أن الطبيعة قد تغيرت (وعلم الفلك الحديث قد عدل تصور كوبر نيكوس عن النظم الفلكية والحركات الكونية المرة بعد المرة، ولا أحد يعرف متى سيأتي التعديل القادم، وفي كل مرة نقول أن فهمنا قد تغير، ولا يقول أحد أن حقائق الطبيعة هي التي تغيرت) .. هكذا نفهم نحن كيف تكون الشريعة المنزلة ثابتة لا تتبدل بينما يمكن أن يتطور فهمنا لها لتظل صالحة لكل زمان ومكان .. هذه ليست مقولات إنشائية ولا عبارات نرصها لأغراض دعائية.. ودعونا نناقش القضايا التي ينطوي عليها هذا الكلام.
نحن نؤمن أن نصوص الوحي، التي هي من لدن حكيم خبير، قد احتاطت منذ البداية لكل ما يتخوف منه هؤلاء المعترضون على فكرة صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، فقد جاءت نصوص الوحي في بعض المسائل فعلا بمعان محددة أو ضيقة لا تحتمل تفسيرات متباعدة، وهذه هي التي وجدنا أنها لا تحتاج إلى أي تغيير مهما تغير الزمان والمكان، فهي ترتبط بطبيعة الإنسان من حيث كونه إنسانا .. لم نصطدم بواحدة منها تحتاج إلى مراجعة أو تعديل .. ولم يواجهنا المعترضون بحالة واحدة شعرنا معها بالحرج، أو اضطررنا للف والدوران كما قد يفعل غيرنا مع نصوصهم، ولم نجد في أي لحظة أن مثل هذه النصوص تطالبنا بأن نسلم بشيء يتعارض مع عقولنا أو مع مصالحنا الحقيقية .. وفي أمور أخرى أتى الوحي بنصوص معجزة تحتمل أكثر من معنى، وكلما تغير الزمان وجدنا أحد معانيها مفيدا وصالحا لمواجهة الواقع وبصورة عبقرية .. لكن الشريعة في الموضوعات التي سبق في علم منزلها أنها متغيرة بطبيعتها جاءت نصوصها على هيئة توجيهات عامة ، وترك لنا الشارع فيها حرية التفكير في التفاصيل وفي ابتكار الآليات المناسبة للتطبيق والتي ستخضع بالطبع لظروفنا ولإمكانياتنا ولطبيعة العصر الذي نعيش فيه .. إن إيماننا بصلاحية تعاليم الإسلام ونصوصه لكل زمان ومكان لم ينتج عن ضحالة فكر أو ضيق أفق كما يحاولون تصويره.
* * * * * *
يختلف فهم المجتهدين للنصوص نتيجة اختلافهم في البنية العقلية التي يحملونها واختلاف الخبرات والتجارب التي مر بها كل منهم، كما يختلفون نتيجة لاختلافهم حول القواعد الأصولية التي ينبغي الالتزام بها، وهذه الاختلافات تؤدي لاختلافهم في فهم دلالة النص في أي عصر معين، ولكن الانتقال من عصر إلى آخر يضيف عوامل جديدة للخلاف، فاختلاف العصور يعمل على تغيير إدراك الناس لحقيقة الواقع ولأولوياته وضروراته .. إلخ، ونتيجة تغير إدراك الواقع فإن فقيهين بذات البنية العقلية وباستخدام ذات القواعد الأصولية يمكن أن يصلا إلى حكمين مختلفين في ذات القضية إذا لم يكن اجتهادهما في نفس العصر وفي ذات البيئة .. ما نعنيه بالاختلاف نتيجة تعدد الأفهام غير ما نعنيه بالاختلاف نتيجة التغير في إدراك الواقع، إنهما شيئان مختلفان تماما.
عندما يختلف المجتهدون في فهم دلالة نص معين أو في الحكم على ثبوته أو في تقدير مدى حجيته، فإنهم يصلون في القضية الواحدة إلى أحكام مختلفة، ولا يملك أي منهم دليلا يقطع بخطأ الآخرين، فتقف كل الآراء متجاورة ولسان حال كل منهم هو ما قاله الشافعي: فكرنا صواب حتى يثبت خطأه، وفكر غيرنا خطأ حتى يثبت صوابه.. أما نحن غير المجتهدين، فلا نملك وسيلة للترجيح العلمي بين هذه الآراء، ولكننا مع ذلك لابد أن نختار واحدا منها فقط، إما أن تقنت في صلاة الفجر أو تترك القنوت، إما أن تصلي تحية المسجد والإمام قائم يخطب الجمعة أو تجلس بغير صلاة، إما أن تقطع الحكومة يد النشال أو تسجنه تعزيرا، نحن هنا نقف أمام بدائل تبدو بالنسبة لنا متساوية القيمة تماما من حيث تعبيرها عن مراد الله، ونحن معشر عوام المسلمين لا نملك من العلم الشرعي ما يمكننا من أن نبني اختياراتنا على أية معايير علمية من وجهة نظر العلوم الشرعية، إنما نحن نختار الرأي الذي نرتاح إليه، أو الشائع في مجتمعنا، أو الذي يلائم أسلوب حياتنا، أو الذي يقول به عالم نثق به أكثر من غيره .. إلخ، المهم أن العلماء متفقون على أنه ليس اجتهاد مجتهد بأولى بالإتباع من اجتهاد مجتهد آخر.
أما تغير إدراكنا للواقع نتيجة الوصول إلى معارف جديدة أو بسبب تراكم الخبرة بفعل مرور الزمن فقد يؤدي إلى ظهور اجتهادات جديدة لم تكن موجودة، أو إلى بطلان اجتهادات لم تكن تأخذ هذه المعارف في حسابها، وحتى إذا لم تتغير الاجتهادات فان اختيارات الناس قد تتغير نتيجة لتغير معاييرهم في الاختيار، والأمثلة على ذلك عديدة، مثلا: كل مواقيت الإحرام للحج تقع على الطرق البرية المؤدية إلى مكة، وعندما تطورت وسائل النقل بحيث أصبح الوصول بالطائرات يمثل نسبة كبيرة من عدد الحجاج، ظهر اجتهاد حديث يقول بجواز الإحرام لركاب الطائرات من جدة لأنهم لا يمرون على أي من المواقيت، وسواء قبلنا هذا الاجتهاد أم لا، فهو اجتهاد معتبر لعالم مشهود له، ومن المؤكد أن هذا الاجتهاد لم يكن ليخطر ببال أحد قبل اختراع الطائرات، وحدث العكس في قضية أخرى، فقد احتاجت المذاهب كلها لتحديد أقصى مدة حمل ممكنة لأغراض تتعلق بالعدة والمواريث.. الخ، فتراوحت التقديرات من سنتين إلى خمسة سنوات حسب علوم عصرهم، أما الآن، وبعد تقدم العلوم الطبية، فلم يعد من الممكن قبول مثل هذه الأحكام، ولا يجوز لأحد أن يزعم في هذا الصدد أنه سيأخذ برأي الإمام الشافعي مثلا.
وقد ظهر أثر تغير إدراك الواقع على الاختلاف في الاجتهاد منذ عصر الصحابة، فالرسول (ص) قد أباح للنساء الخروج إلى المسجد في حديثه "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"، لكن بعد وفاته رأت السيدة عائشة أن أخلاق النساء قد تغيرت، فقالت: "لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد"، نحن نفضل بالطبع رأي عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة ممن رفضوا اجتهاد السيدة عائشة (رض)، لكن المهم أن أحدا ممن رفضوا اجتهادها لم يرفض المبدأ الذي اجتهدت على أساسه، ولم يتهم أحد أم المؤمنين في فقهها عندما رأت أن تغير الواقع قد يقتضي تغير الحكم.
وسمع الصحابة آيات سورة الحشر الواردة في توزيع الفيء، والتي تبدأ من الآية السابعة "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم .." وتذكر الآيات للمهاجرين نصيبا في الآية الثامنة، وللأنصار في الآية التاسعة، ثم تذكر في الآية العاشرة "والذين جاءوا من بعدهم .." سمعوها من الرسول (ص) مرات عديدة، ومنه حفظها أغلبهم، ومع أن الآيات واضحة في أن الذين "جاءوا من بعدهم" لهم أيضا حق في الفيء فقد طلبوا من عمر بن الخطاب أن يوزع أرض العراق على المقاتلين الذين قاموا بالفتح، ولم يستسغ عمر الفكرة وأراد أن يحتفظ بملكية الأرض لبيت مال المسلمين حتى يظل عائدها حقا لكل أجيال المسلمين لا يستأثر به أبناء الفاتحين وحدهم، واستغرق الأمر ثلاثة أيام كاملة من المناقشات حتى انتبه عمر (رض) إلى أن آيات سورة الحشر تؤيد موقفه، فذكرهم بها، وانتهى الأمر عند ذلك وقبلوا رأيه (د. يوسف القرضاوي، "السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها")، لكن أحدا لم يقل في البداية أن هناك نص في الموضوع، لأن أحدا لم يدرك دلالة هذا النص إلا عندما احتكوا بالواقعة.
واختلف الأئمة الأربعة في حكم الصلاة في المقبرة بين كاره لها ومبيح دون أن يرى واحد منهم أنها حرام، ثم جاء ابن تيمية في القرن السابع الهجري فحرمها وشدد في تحريمها، مذكرا بحديث رسول الله (ص) الذي كان معروفا ومدونا من قبل: "لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك"، ويعلق الشيخ محمد الغزالي رحمه الله على موقف ابن تيمية المخالف للمذاهب الأربعة فيقول: ".. إن تغير الناس هو السبب في اختلاف الحكم، فما كان المسلمون الأوائل يذهبون إلى مقبور يلتمسون منه شيئا، ومن ثم لم يشعر المفتون قديما بأن الأمر يستحق الحظر والوعيد فحملوا الحديث على الكراهة لا التحريم [التشديد من عندنا –ع]، أما في القرن السابع – عصر ابن تيمية – فإن أعدادا من العامة كانت تستجير من التتار الغازين بقبر أحد الصالحين .. كيف يقع هذا؟ .. إن ذلك ما جعل الرجل يتشدد في إنفاذ كلام رسول الله ألا يبنى على القبر مسجدا، وألا يصلى في مقبرة" (الشيخ محمد الغزالي، "مائة سؤال في الإسلام") لم يكن ابن تيمية إذن أكثر احتراما للنصوص من الأئمة الأربعة، كل ما في الأمر أنه رأى ما لم يره أحد منهم، فأدرك أن الحديث ليس للتغليظ والتنفير، لكنه للمنع والحظر، فنقل الحكم من الكراهة إلى التحريم.
ومثال أخير أكثر اتصالا بالمسائل العامة: لقد وردت الأحاديث الصحيحة الواضحة في رفض رسول الله (ص) لتسعير السلع، مفضلا ترك الأسعار لتتحدد حسب علاقات العرض والطلب، ومع ذلك نجد الفقهاء التقليديين يقبلون الإفتاء بالتسعير، رغم حرصهم الشديد على القياس الجزئي والتمسك بحرفية النصوص، دفعهم إلى ذلك ما كان سيترتب على رفض التسعير من ظلم بين، ومع أنهم أدركوا أن فتواهم هذه تخضع لأحكام الضرورة، وأنها خروج على الأصل العام الذي يحترم موازين القوى الاقتصادية وقواعد السوق، فإن واحدا منهم لم يخطر بباله البحث عن قواعد تنظم العلاقات الاقتصادية ليعالج الأمر معالجة كلية تعيد إلى التنظيم الاقتصادي توازنه الكلي، وتعود بالسوق إلى الوضع الطبيعي الذي تنتفي فيه الحاجة إلى التسعير، فلم يكن منهم من يدرك أن للسلطات العامة وسائل أخرى للتأثير على الأسعار والسيطرة عليها بخلاف التسعير، لذلك لم يخطر ببال واحد منهم أنه في حالة اختلال هيكل الأسعار يكون مفروضا على الدولة فريضة شرعية أن تلجأ إلى آليات توجيه الاقتصاد وسياسات المالية العامة لإصلاح الوضع حتى تخرج من حالة الضرورة التي استندت إليها للتدخل في الأسعار.
* * * * * * * *
من الواضح إذن أن المجتهد يستنبط رأيه الفقهي من المزاوجة بين ما يفهمه من النصوص وما يدركه من واقع العصر الذي يعيش فيه، والنصوص الظنية تعطي بنفسها طائفة من الدلالات، وتأثر المجتهد بواقعه يستبعد جزءا لا بأس به من هذه الدلالات، بعضها يستبعده بوعي بعد أن عرفه لأنه في رأيه يفتقر للملائمة، وبعضها يتم استبعاده بغير وعي لأن حدود واقعه جعله لا يرى هذه الدلالات من الأصل (كما لم يدرك الصحابة الكرام دلالة آيات سورة الحشر عن حق "الذين جاءوا من بعدهم" في الفيء إلا بعد أن واجهوا من الحوادث والقضايا ما وسع إدراكهم ليفهموا ما استقر عليه الأمر في النهاية) .. ومما احتمل الصحة عند مجموع المجتهدين في أي عصر نصل إلى عدد محدود من الأحكام في كل قضية، فينحاز كل مجتهد حسب تركيبه العقلي وخبراته وتجاربه وثقافته وطبيعة البيئة التي يعيش فيها والعرف السائد بين الناس الذين يجتهد لهم إلى واحد منها ليؤصله ويوضحه ويبني عليه اجتهاده، فتتكون بذلك مجموعة الاختيارات الفقهية المقبولة شرعا التي يمكن الذهاب إلى واحد منها في هذا العصر.
ويأتي عصر جديد بواقع مختلف، وما كان يعد أفضل الممكن صار حلا متخلفا لا يحقق المصلحة، وما كان ينظر إليه على أنه من اللمم الذي يمكن التغاضي عنه ولا يستدعي الحظر اتضح أنه أمر خطير على المدى البعيد ويسبب أضرارا لا ينبغي السكوت عليها، والأمر الذي لم نكن نتصور أن السلطات العامة لها دور فيه اكتشفنا أن تنظيمه وخضوعه للقانون ممكن ومحقق لمصالح جمة ينبغي السعي في سبيلها، وتطورت أساليب الإنتاج وعلاقات التجارة الداخلية والخارجية مما صار يستدعي تنظيما لمسائل لم يكن أحد يتصور أهمية التدخل فيها من قبل .. في هذا الواقع المختلف فإن بعضا مما كان اجتهاد السلف يعده ضروريا يجب الحرص عليه، أو يراه ضارا يجب محاربته، لن نجده كذلك، ويغدو اجتهاد السلف في هذه المسائل قمينا بالاستبعاد .. في هذه الحالة يعد الاستناد إلى الرأي السابق خطأ في الاستنباط .. ومع ذلك قد يصر بعض الجامدون على استبقاءه بدعوى أن ذلك إتباعا لمنهج السلف، وما كان هذا منهج السلف، فإتباع واحد من هذه الآراء لم يعد محققا لمراد الله، وسنفشل إذا اتبعناه برغم نجاح السلف به، فما كان أفضل الممكن في عصرهم لم يعد كذلك بعد أن هدانا الله في الزمان الجديد إلى ما هو أفضل منه.
وفي هذا العصر الجديد قد يعود الراسخون في العلم من المجتهدين إلى قبول بعض الدلالات التي عرفها السابقون واستبعدوها استجابة لواقعهم هم، ولكن الواقع الجديد يقبلها، ثم هؤلاء الراسخون في العلم قد يمكنهم الواقع الجديد من إدراك دلالات كانت كامنة دائما في النصوص، ولكنهم أدركوها الآن فقط عندما ساهم الواقع الجديد في توسيع مداركهم .. وبذلك يغدو مقبولا لدى هذه المجموعة من المجتهدين أحكاما لم تكن معروفة عند السلف، وينشأ صراع بين الجامدين والمجددين، وفي وسط الإحباط والبلبلة نتيجة بعض حالات الفشل، يأتي دور المنهزمين الذين يحاولون تغطية هزيمتهم بغطاء شرعي .. فليست القاعدة أنه بعد كل فشل علينا إتباع المجددين، لا .. علينا أولا التمييز بين المجدد من الداخل الذي تمثل استنباطاته الجديدة جزء من الدين، وبين حمامة الغية التي جاءت بكلام يبدو في ظاهره ككلامنا بينما نتيجته هي إخراجنا من ديننا ... لتستمر حكمة الابتلاء ولا تكون هناك وصفات جاهزة مجربة نتبعها لمجرد أننا نرغب في تحقيق نتائجها، بل يجب علينا دائما في كل عصر أن نكد ونكدح إلى الله "يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه" الانشقاق: 6، تكدح الصفوة من المثقفين والمفكرين والعلماء في استنباط الأحكام، وتكدح العامة لتحدد موقفها من الصراع بين الأفكار، ويكدح الجميع لفهم أسباب فشل الوصفات التي نجحت في السابق، ويبقى لدى كل جيل مشاكله التي لن يحلها إلا بالإخلاص والمعاناة والكدح إلى الله.
* * * * * *
يرى بعض المتدينين أن صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان هي من القضايا التي ينبغي التسليم بها دون مناقشة لأنها من قضايا الإيمان، ومع ذلك فهي من القضايا التي يمكن إثبات صحتها في إطار منهج البحث العلمي، فمن وجهة نظر هذا المنهج يعد فشل المعترضين في إقامة الدليل على كذب أي فرضية مبررا كافيا لاعتمادها كنظرية علمية مقبولة، وقد أمكننا على الدوام تفنيد كل الاعتراضات التي تثار ضد صلاحية شريعة الإسلام للتطبيق، كما نملك البرهنة على أن المسلمين لم يعجزوا في أي وقت عن اكتشاف حلول ملائمة ونابعة من شريعتهم .. ومع ذلك فينبغي التأكيد على أن هذه الصلاحية لا تعني في نظرنا أن كل حل يتم استنباطه من نصوص هذه الشريعة سيكون صالحا، فالحلول يستنبطها البشر بكل ما فيهم من قصور، لذلك ينبغي أن ينسب الحل لمن ينادي به لا إلى الشريعة (لا يتخذ صفة الإلزام إلا رأي أجمع عليه العلماء، وقد نتصور إجماعهم على فهم معين لنص من النصوص، لكنا لا نتصور أن يجمعوا على فهم واحد للواقع ومشكلاته وإمكانياته في أي قضية، لذلك لا نتوقع أن يظهر أي حل لأية مشكلة عملية يحمل صفة الإلزام الشرعي، مع أنه غير مستحيل في العقل).
نحن ندافع عن هذا المبدأ في مواجهة المعارضين للمشروع الإسلامي، لا يحق لهم أن يمنعونا من محاولة صياغة المجتمع والدولة على أسس إسلامية بدعوى أن الإسلام لم يعد صالحا لهذا الزمان، ومع ذلك فمن حق كل الناس أن يناقشوا الوسائل التي نريد إتباعها والنظم التي نحاول تطبيقها، ويمكنهم أن يرفضوا بعضها أو يرفضوها كلها لعيوب يرونها فيها دون أن يكون هذا بالضرورة رفضا للإسلام أو اعتراضا على حكم الله، والفصائل الإسلامية نفسها تختلف فيما بينها حول ما يعتبره كل منها التطبيق الأفضل لشريعة الإسلام ويخطئ بعضها بعضا .. ولا شيء في هذا.
إن صلاحية الشريعة لإنتاج أفضل الحلول في كل زمان وفي كل مكان لا يعني أن كل حل يستنبطه البعض منها سيكون حتما حلا ملائما، إن الاستنباط من الشريعة هو كقيادة السيارات: لن تصل إلى هدفك لمجرد أنك تستخدم سيارة صالحة، لابد أن تعرف الطرق التي أمامك، وأن تعرف مكان الهدف الذي تريد الوصول إليه، وكما يفشل بعض الناس في بلوغ أهدافهم برغم صلاحية السيارات التي يقودونها فقد يفشل بعض المسلمين في معرفة الحلول الملائمة لمشاكلنا دون أن ينسب هذا الفشل للشريعة، بل ينسب الفشل لمن عجز عن التعامل معها بكفاءة .. إن الرغبة في تطبيق الشريعة ليس شرطا كافيا للنجاح، ولكننا نصر على أنه شرطا لازما .. سيفشل كل حل يحاول أن يأخذ المسلمين بعيدا عن شريعتهم.