البطالة والبنية التحتية والمدن الجديدة .. مقال في إقتصاديات التنمية
منذ 11 شهور | 14085 مشاهدات
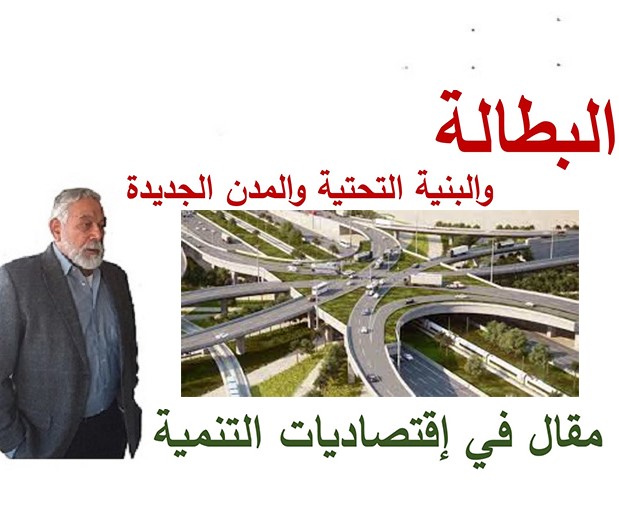
تشغل قضية البطالة مكانا محوريا في مباحث علوم الإقتصاد والتخطيط، وما أعرضه هنا هو تبسيط لنظرة علمية صرف، والأفكار العلمية يفترض فيها الحياد، فإذا بدا في ما أعرضه أية متضمانات سياسية فإن هذا يرجع إلى طبيعة الموضوع، ولا علاقة له بإنحيازي الفكري.
هل يمكن لمشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة أن تؤثر في معدل البطالة؟ .. لا توجد علاقة مباشرة، فخفض نسبة البطالة يرتبط بالتنمية الإقتصادية، وعلى الأخص بالمشروعات الإنتاجية التي كلما توسعت زادت الحاجة لتشغيل العمال وانخفضت نسبة البطالة، أما نشاط قطاع التشييد بصفة عامة فقد يكون مفيدا للتنمية الإقتصادية وقد لا يكون، وفي بعض الأحيان يكون التوسع في البنية التحتية والمشروعات الإنشائية معرقلا لجهود التنمية، لا تؤثر البنية التحتية والمدن الجديدة على البطالة إلا بالقدر الذي تساهم به في خدمة المشروعات الإنتاجية.
فالبنية التحتية، من إسمها، ليست إلا الأساس الذي تقوم علية البنية الفوقية الإنتاجية، فقطاع التشييد يقوم بإستصلاح الأراضي، لكن التنمية ترتبط بزراعة الأرض لا بإستصلاحها، ومد الأرض بالمرافق وإقامة المباني الصناعية عليها ضروري لإيواء خطوط الإنتاج، ولتخزين مستلزماتة ومنتجاته، لكنها في حد ذاتها لا تحدث تنمية إلا إذا وضعت فيها معدات الإنتاج وتم تدريب العمال والمهندسين على إستخدامها، والطرق والكباري ليست لها قيمة إنمائية إلا بإرتباطها بمراكز الإنتاج التي تحتاج إلى إستجلاب المواد الخام ثم نقل المنتجات إلى مراكز الإستهلاك، والمراكز التجارية والإدارية (والمشروعات العقارية الأخرى التي تزخر بها المدن الجديدة) لن تفيد التنمية إلا إذا كان هناك مشروعات إنتاجية تحتاج إلى مكاتب للإدارة ومنافذ لتوزيع منتجاتها وبنوك لتمويل أعمالها .. وهكذا.
ولا شك أن شبكات الكهرباء والإتصالات والتغذية بالمياة وصرف المخلفات وغيرها من مكونات البنية التحتية هي مما تحتاجه المشروعات الإنتاجية التي هي عصب التنمية، لذلك لا تكاد تخلو أي خطة جيدة للتنمية من مشروعات للبنية التحتية وأخرى ذات طبيعة عقارية من مخرجات قطاع التسييد، هذا صحيح، لكن إذا كان التنفيذ يبدأ بمشروعات البنية التحتية فإن التفكير فيها وإتخاذ القرارات بشأنها لابد أن يأتي لاحقا لإتخاذ القرارات المتعلقة بالتوسع في مشروعات الإنتاج، نوعيتها وطبيعتها وإحتياجاتها وأنسب المواقع لها .. إلخ، بالضبط كما تكون الأساسات هي أول ما نقوم بتنفيذه لكن تصميم العمارة نفسها لابد أن ينتهي قبل أن نبدأ التنفيذ .. تبدو هذه بديهية، فلا يوجد عاقل يبدأ برمي الأساسات دون أن يكون قد إنتهي من إعداد تصميمات المبنى بالكامل.
وهذا يقودنا لمسألة التمويل، خاصة لو كان سيتم بالإقتراض، فلابد أن تحدد حجم التمويل اللازم للعمارة كلها، الأساسات والأسقف والتشطيب وإدخال المرافق، وأن تطمئن إلى قدرتك على تمويل كل هذه الإعمال، فأنت لا تستطيع سداد أقساط التمويل إلا إذا تمكنت من إنهاء العمارة لإستغلال وحداتها، إما إذا إستنفذت كل التمويل المتاح في عمل أساسات ضخمة وعميقة وممتازة ثم لم يتبق لك ما تبني به العمارة فأنت في ورطة كبيرة .. هذا هو ما ستجد نفسها فيه أي دولة تستهلك كل إحتياطياتها وقدرتها على الإقتراض في إقامة بنية تحتية ممتازة ومدن جديدة جميلة، ثم لا يتبقى لها ما تقيم به المشروعات الإنتاجية التي ستستخدم هذه البنية التحتية لتولد الوظائف والدخل، فهذا الدخل هو الذي سنسدد منه تكلفة البنية التحتية.
أما القول بأن المشروعات الإنشائية (من بنية تحتية وإمتدادات عمرانية ومدن جديدة) توفر فرص للعمل تساهم في خفض معدلات البطالة فهو قول غير دقيق (مشيها غير دقيق)، لأن الوظائف في مشروعات التشييد بطبيعتها هي وظائف مؤقتة تختفي بإنتهاء الإنشاء وتعود البطالة لمعدلاتها السابقة، المشروعات الإنتاجية وحدها هي القادرة على تقديم وظائف دائمة تسهم في خفض معدلات البطالة (بالإضافة طبعا لزيادة المتوفر من السلع والخدمات)، فهي قادرة على توليد تمويل مستمر من خلال بيع منتجاتها للإنفاق على دورات إنتاج متتالية ليستمر تشغيل عمالها وعمال المشروعات الأخرى التي تنتج مستلزمات الإنتاج أو تقوم على بيع مخرجاته، لذلك يولي مخططو التنمية أهمية عظيمة للتوازن بين تكاليف البنية التحتية وتكاليف البنية الفوقية، أي المشروعات الإنتاجية التي ستستخدم البنية التحتية، ويعد خطأ قاتلا أن تخصص للبنية التحتية إعتمادات أكثر مما ينبغي فنعجز عن الإستفادة منها لأننا لن نستطيع تمويل بنيتها الفوقية، أما إعتمادات البنية التحتية الأقل من المطلوب فستعوق توسع الإنتاج حتى لو توافر التمويل المطلوب له.
يفترض البعض أن توسع الدولة في البنية التحتية والمدن الجديدة لا بأس به ما دام القطاع الخاص هو المناط به إقامة المشروعات الإنتاجية التي ستسدد للدولة الضرائب التي تسترد بها تكاليف ما أنشأته، قد يكون التفكير بهذه الطريقة مقبولا إذا كانت الدولة تمول البنية التحتية والمدن الجديدة من خارج سوق رأس المال (كجالة الدول النفطية مثلا)، أما إذا كانت ستلجأ للإقتراض من الجهاز المصرفي أو إصدر أذون خزانة أو غيرها من الأدوات التي تمكنها من الحصول على مدخرات المواطنين، كما هو الحال في مصر، فإن هذا سيؤدي إلى نقص كبير في المعروض من رأس المال (أي الأموال التي يمكن للمشروعات الإنتاجية أن تحصل عليها، كقروض أو أسهم أو سندات)، وهذا سيؤدي لرفع سعر الفائدة (بإعتبار أن الفائدة هي إيجار رأس المال)، فتقل قدرة القطاع الإنتاجي على التوسع (توسع المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة) بل أن خطوط الإنتاج الموجودة فعلا ستجد صعوبة في تدبير رأس المال العامل (السيولة) اللازم للحفاظ على نفس مستويات الإنتاج، ويدخل الإقتصاد في حالة إنكماشية تقل فيها الوظائف والسلع والخدمات .. هذا من أساسيات الإقتصاد الكلي التي لا يجهلها أي دارس للإقتصاد.
هذه الأفكار يعرفها كل مبتدئ في دراسة تخطيط التنمية، فهي تمثل واحدا من أهم فصول أي مقرر تمهيدي في هذا العلم، ولله في خلقه شئون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ملحوظة: في حالة إنخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين يتراجع الطلب الكلي فينتج عن ذلك تعطل بعض القدرات الإنتاجية، عندها قد تلجأ الحكومات للإنفاق غير المغطى (تطبع بنكنوت) على البنية التحتية على أساس أن هذا الإنفاق سيزيد القدرة الشرائية للجمهور فيزداد الطلب الكلي فيعاد تشغيل القدرات الإنتاجية التي تعطلت .. هذه هي الوصفة الكينزية، لكنها لا تفيد إلا في حالة إقتصاد متقدم عانى من إنكماش طارئ عطل بعض قدراته، لكنها أبدا ليست وسيلة لإحداث تنمية في إقتصاد متخلف يعاني من قصور في قدراته الإنتاجية، فلزم التنويه.